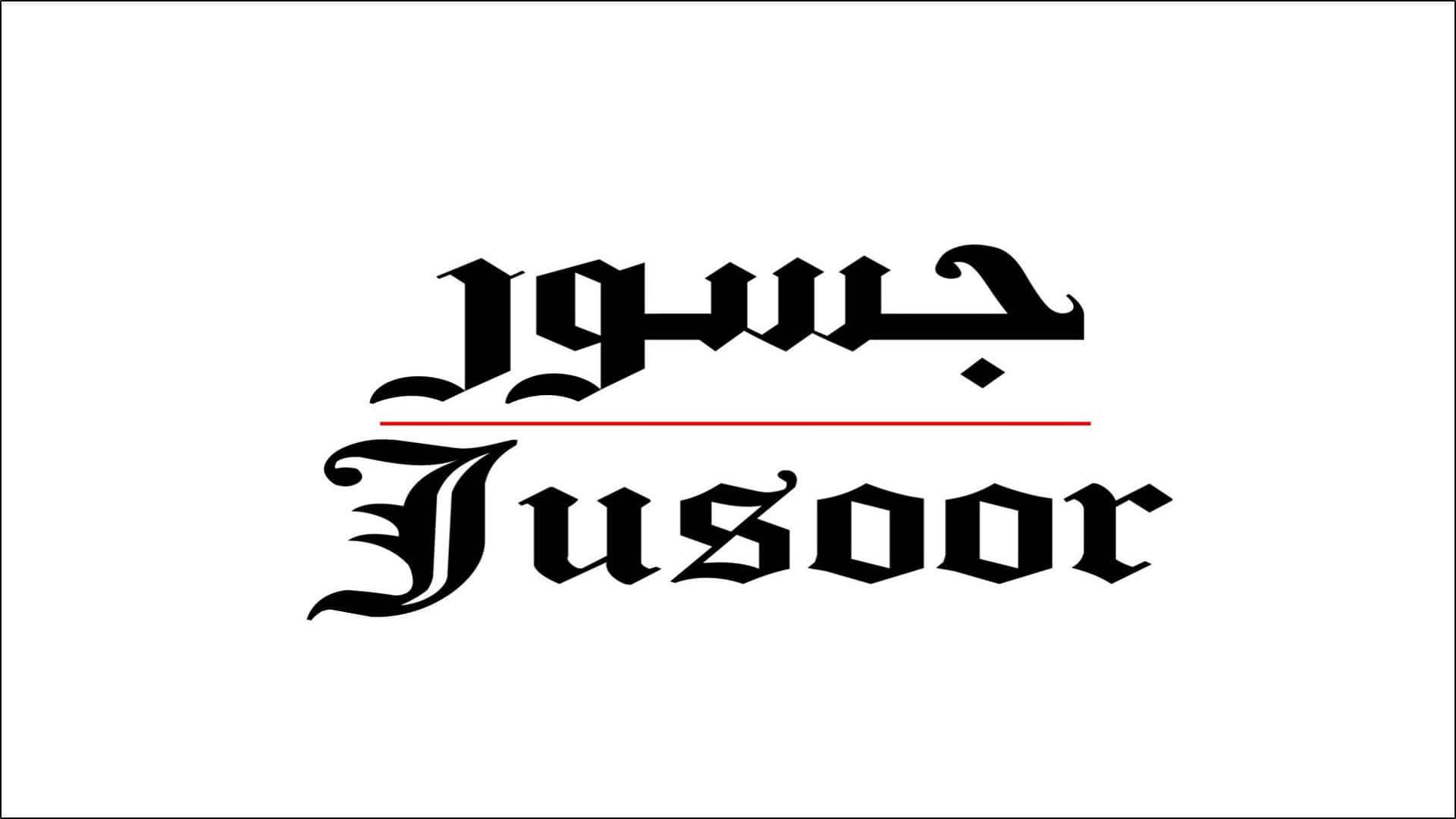"فورين بوليسي": اتفاقية أوسلو.. سلام لم يتحقق وحلم بدولة فلسطينية يتبدد
"فورين بوليسي": اتفاقية أوسلو.. سلام لم يتحقق وحلم بدولة فلسطينية يتبدد
في عام 2003 كانت الضفة الغربية لا تزال تتعرض للضربات العسكرية، وواجهتها الخارجية الملساء من الحجر الجيري مليئة بثقوب الرصاص، والطرق محطمة تحت وطأة الدبابات الإسرائيلية.
شنت القوات الإسرائيلية غزواً واسع النطاق على العديد من المدن في الضفة الغربية، بما فيها رام الله، للقضاء على القيادات الفلسطينية، بمن فيهم ياسر عرفات، ولتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، بحسب "فورين بوليسي".
تقول صحفية "فورين بوليسي"، صاحبة الإقامة المشتركة بين الولايات المتحدة والضفة الغربية، داليا حاتوقة: "الفلسطينيون الذين يعيشون هناك كانوا تحت حظر التجول بشكل متقطع لأسابيع في كل مرة.. وكانت الدبابات تجوب الشوارع، وأطلقت طائرات الأباتشي المسلحة النار على وزارات السلطة الفلسطينية ومراكز الشرطة، وحتى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 كانت تقوم بعمليات اغتيال خارج نطاق القانون".
تروي "حاتوقة" قائلة: "لقد مر الفلسطينيون بكل ذلك، وكان الشيء الجيد هو كيفية تمسكنا ببعضنا البعض، ومساعدة بعضنا البعض، ومشاركة الطعام أثناء حظر التجول، والطهي للمبنى بأكمله، واستعارة كل ما نحتاج إليه من بعضنا البعض".
تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية القبيحة من الدمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، إلى الاعتقالات والاحتجاز والقتل على نطاق واسع.
وكانت هناك جيوب صغيرة من الحرية، عندما اختفت الدبابات الإسرائيلية، كنا نسير لمسافات طويلة في الحي، ونتجول في الشوارع فقط لنكون في الخارج ونتذكر كيف كان شعور الريح على وجوهنا، في بعض الأحيان كنا نتسلل إلى منازل الأصدقاء ونبقى حتى يتم رفع حظر التجوال.
وفي الأيام التي كنا فيها شجعانا بشكل استثنائي، كنا نغامر بالذهاب إلى أريحا، التي على الرغم من كونها محاصرة، فقد نجت من مصير جنين والخليل والمدن الأخرى التي تمت مهاجمتها في أبريل ومايو 2002.
كانت هذه أول مدينة يمنح الإسرائيليون الفلسطينيين السيطرة المدنية والأمنية الكاملة عليها، وحولت بلدة صحراوية كانت نائمة ذات يوم -معروفة بطقسها المعتدل في الشتاء- إلى مركز سياحي.
في عام 1998، في ذروة هذه السنوات الهادئة، أصبح فندق إنتركونتيننتال أريحا وكازينو الواحة المجاور رمزا للسلام الذي يمكن أن يكون، كان الإسرائيليون والأجانب على حد سواء يترددون عليه، ويختلطون مع الموظفين الفلسطينيين، الذين منعوا من لعب القمار ولكن سمح لهم بالعمل هناك.
لكنه كان سلاما لم يتحقق أبدا، في أعقاب الانتفاضة الثانية، وخاصة بعد غزو الضفة الغربية عام 2002، تبخر قطاع السياحة الناشئ في أريحا ومات مصدر رئيسي للدخل.
في يوم دافئ في يناير 2003، قررت أنا وصديقي الذهاب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك.
خططنا للمغادرة خلال نافذة الست ساعات عندما تم رفع حظر التجول للناس للذهاب لشراء البقالة ، والعودة بعد يومين عندما تم رفعه مرة أخرى.
لقد كان امتيازا لا يستطيع سوى عدد قليل جدا تحمله، وكنا نعلم أننا محظوظون لأننا قادرون على التظاهر بأن الاحتلال لم يكن موجودا لعدة أيام.
لكن الفندق نفسه عكس الواقع المحزن لفشل ما بعد "أوسلو" كانت الغرف نظيفة، ولكن كانت حمامات السباحة فارغة عمليا، كان اللوبي قاتما ومحروما من الحياة.
كاثنين من أصل 10 ركاب آخرين، عرض المدير أن يرينا المكان، كان الأمر أشبه بالدخول إلى كبسولة زمنية محفوظة تماما.
تم الحفاظ على طاولات البلاك جاك الخضراء بطريقة صحيحة، وتم وضع ملاءات بيضاء على الكراسي الفخمة وماكينات القمار وعجلات الروليت لحمايتها من الغبار والوقت، ربما علامة أمل في استخدامها مرة أخرى في وقت قريب.
حتى إن الرقائق ملقاة على الطاولات، منتشرة في أبراج صغيرة مثالية، في انتظار رهان لن يأتي أبدا، كان الأمر أشبه بالتقاط لقطة شاشة لذروة فترة أوسلو.
أما جمال، بحسب المجلة فهو شاب فلسطيني عمل هناك خلال تلك الفترة، قال إنه كسب مبلغا لا بأس به من المال في ذلك الوقت، وهو ما يكفي لدفع ثمن شهادته الجامعية، في وقت سابق من هذا العام، كان عاطلا عن العمل، وشهادته مؤطرة، في انتظار أن يتم تعليقه في مكان ما.
اليوم، يقول جمال إن أوسلو كانت واجهة، وخلال أفضل ساعاته، كان قادرا على قيادة سيارته الفلسطينية مباشرة إلى تل أبيب، لم يكن خائفا من التحدث باللغة العربية داخل إسرائيل، لكن هذا كل ما كان عليه.
ويضيف جمال، رحلات الشاطئ والحفلات والحرية التي جاءت على حساب أشياء أخرى كثيرة، عندما انفجرت الفقاعة، كان أول من ذهب هم الشباب الفلسطينيون الذين احتجوا خارج عوفر -السجن والمحكمة والمنشأة العسكرية بالقرب من رام الله- وألقوا الحجارة، وهناك، قوبلوا بالذخيرة الحية.
جلبت السنوات التي تلت ذلك معها تغييرات بدت وكأنها تشير إلى حقبة أكثر هدوءا واستقرارا، لكن هذه التغييرات أخفت فقط القوى الكامنة التي استمرت في إملاء الحياة في الضفة الغربية وغزة.
بعد وفاة ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس في عام 2005، كان هناك الكثير من الاهتمام الدولي بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وقدرة قواتها الأمنية على فرض القانون والنظام.
وفي عهد رئيس الوزراء سلام فياض (2007- 2013)، بدأنا نحن الفلسطينيين نرى ببطء طرقنا وقد أعيد رصفها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، انتشرت المقاهي الفاخرة في كل زاوية أخرى وبدأ الناس في الحصول على قروض للمنازل والسيارات وحتى أجهزة “أيفون”.
الحياة، كما عرفناها، تغيرت أمام أعيننا، أصبح شارع الطيرة، حيث كنت أعيش مع عائلتي، مركزا للمطاعم والمقاهي الصاخبة، وفي أماكن أخرى، كانت هناك منافذ كنتاكي فرايد تشيكن جديدة وشقق لامعة وجديدة تماما.
وانتشرت مجتمعات مسورة حول رام الله، وأغلقت السيارات الراقية الشوارع المزدحمة، وكثير منها ينتمي إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية والفلسطينيين من الطبقة المتوسطة العليا الذين استفادوا من الوضع الراهن.
إن "السلام الاقتصادي" الذي لا يزال يدافع عنه القادة الإسرائيليون والفلسطينيون بصخب، موجود بالفعل منذ بضع سنوات، كان مثل أوسلو، وعلى الرغم من أن عهد فياض قد اتسم بتدفق غير مستدام لرأس المال الأجنبي، ومعظمها تحت ستار المساعدات، فإنه لم يلبس سوى الحقيقة القبيحة للسيطرة الإسرائيلية.
في حين أنه صحيح في ذلك الوقت كان بإمكانك القيادة من رام الله إلى نابلس وبالكاد ترى جنديا إسرائيليا، فقد تم سحق غزة عسكريا عدة مرات، ما أسفر عن مقتل مئات الأطفال الأبرياء، واستمر بناء المستوطنات بلا هوادة.
أخيرا، انهار كل شيء مرة أخرى، وبحلول عام 2013، وصل العداء بين فياض وعباس إلى نقطة الانهيار.
إن قضية فياض مفيدة، رجل كان محبوبا للغرب، فقد جاء من صندوق النقد الدولي، ونفذ إصلاح القطاع الأمني، وتخلص من الجماعات المسلحة، ونفذ الإصلاح الاقتصادي، وأدخل الأدوات المالية التي طورتها الولايات المتحدة إلى سوق الإسكان في الضفة الغربية.
بعبارة أخرى، لقد فعل كل ما يريده الأمريكيون، وكل ما يريده الإسرائيليون، وكل ما يريده دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيا.
بالنسبة للفلسطينيين العاديين، كانت خطوة أخرى اتخذوها لاسترضاء إسرائيل والمجتمع الدولي، لكنها لم تجعلهم يقتربون من المساواة في الحقوق، ناهيك عن دولة خاصة بهم.
على مر السنين، تلاشت الانتفاضة لكنها تحولت إلى مظاهر ومسميات مختلفة: "انتفاضة السكاكين"، "انتفاضة الدهس"، "انتفاضة الذئب المنفرد"، و تكهن المراقبون وأقسم البعض أن هذه ستكون الانتفاضة الثالثة للسيطرة على الضفة الغربية، لكن هذا لم يحدث أبدا.
ومع ذلك، تزايدت الهجمات على الإسرائيليين وبدأ الفلسطينيون في استخدام طرق جديدة للانتقام.
وكان عام 2014 ذروة الهجمات المؤقتة غير المنسقة التي نفذها في الغالب شبان لا ينتمون إلى الأحزاب التقليدية، بدؤوا في استخدام سكاكين المطبخ أو صدم سياراتهم على الأرصفة، لم تكن السلطات الإسرائيلية تعرف ماذا تفعل من هجمات الذئاب المنفردة هذه، لذلك استمرت في القيام بما تفعله بشكل أفضل وهو معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي.
وهدمت معظم، إن لم يكن كل، المنازل التي كان يعيش فيها المهاجمون والمشتبه بهم، وتحولت منازل أسرهم إلى أشلاء في كثير من الأحيان في جوف الليل، هذا ما حدث لعائلة عبدالرحمن شلودي من سلوان.
في 22 أكتوبر 2014، قاد عبدالرحمن سيارته إلى محطة قطار خفيف في القدس، في حادث دهس ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما رضيع، وبعد أقل من شهر، دمرت شقة عائلته، فيما كان ميتا بالفعل، حيث قتل في موقع الدهس، لكن عائلته عوقبت.
تقول داليا حاتوقة أتذكر “إيناس” والدة عبدالرحمن، وهي جالسة على أريكة قديمة مهترئة في المبنى المكون من 4 طوابق الذي كانت شقتهم فيه، ترك الهدم 7 أفراد من عائلة شلودي المباشرة -والداه وولدان و3 بنات- بلا مأوى.
في تلك المرحلة، كانوا يقيمون مع العائلة الممتدة في المبنى حتى يكتشفوا ما يجب فعله بعد ذلك، لن أنسى أبدا وجهها المهيب أو ما قالته لي: "العنف يولد العنف".
لقد مرت 30 عاما منذ توقيع أوسلو، وقد يقول البعض، لقد تغير الكثير، ولكن بطريقة ما، لم يتغير شيء، وحتى خلال ذروة سنوات السلام، استمرت المستوطنات بلا هوادة، وانتشرت في جميع أنحاء الضفة الغربية.
في هذه الأيام، يعيش نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، أسقفهم اللامعة من القرميد الأحمر دليل على أنهم في غير مكانهم، إنهم يعيشون على قمم التلال والعين على الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم لإفساح المجال لمنازل المستوطنين وحمامات السباحة.
لقد تشجعوا من قبل الدولة الإسرائيلية وعنفهم لا يعرف حدودا، وتحملت بعض القرى والبلدات وطأة هذا العنف الذي أقرته الدولة أكثر من غيرها.
وفي فبراير الماضي، اجتاح مئات المستوطنين الإسرائيليين حوارة بالقرب من نابلس، ما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة مئات آخرين بجروح.. أحرقوا السيارات وأحرقوا المنازل.
كان العنف وحشيا لدرجة أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وصفه بأنه "مذبحة".
وعلى الرغم من الدمار، لا يزال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى "محو" حوارة، وهي تعليقات وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها بغيضة.
لكن عشرات مقاطع الفيديو التي ظهرت من مشاهد لهجمات مماثلة أظهرت جنودا إسرائيليين يقفون مكتوفي الأيدي، غير راغبين في حماية السكان بينما يضرم المستوطنون النار في منازل الفلسطينيين وشركاتهم ويمنعون خدمات الطوارئ من الاستجابة.
وتحدث الآن الهجمات والمضايقات من قبل المستوطنين بانتظام، مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.
وبعد مرور 30 عاما، يأتي الغضب والإدانة الدوليان ويذهبان، والأسوأ من ذلك كله من وجهة نظر الفلسطينيين، أنهم لا يتمتعون بتمثيل سياسي شرعي، لا يزال محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، رئيس كل شيء، كما يقول جمال، وقد كان كذلك منذ انتخابه في عام 2005.
على مدى العقدين الماضيين، تم تقديم الكثير من الوعود بإجراء الانتخابات ونكثها، وتبدأ الآمال عاليا ثم يسحقها عباس في اللحظة الأخيرة.
تنبأ إدوارد سعيد في عام 1993 بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستصبح المنفذ لإسرائيل، وهذا ما حدث بفضل اتفاقية أمنية بين الاثنين وصفها عباس ذات مرة بأنها "مقدسة".
ومما لا يثير الدهشة أن شرعية السلطة الفلسطينية قد تعرضت لتحديات متزايدة، معظمها من قبل الشباب الفلسطينيين الذين يرون فيها طبقة إضافية لقمعهم، بالإضافة إلى السلطات الإسرائيلية التي ترتبط بها السلطة الفلسطينية بلا هوادة.
لقد أصبحت البطالة والفقر واليأس هي القاعدة هنا في الضفة الغربية، كانت أوسلو سرابا تلاشى بالسرعة التي استغرقت بها حبر الاتفاق.
واليوم، لم يعد فندق إنتركونتيننتال في أريحا، الذي كان في يوم من الأيام رمزا لما ستكون عليه الحياة المشتركة مع الإسرائيليين، تم تخفيض تصنيفه من فندق 5 نجوم وأعيدت تسميته إلى Oasis، ربما تكريما للكازينو المجاور البائد.
لا يزال الفلسطينيون يتدفقون عليها خلال الصيف الحار وأيام الشتاء الأكثر دفئا، لكنهم المحظوظون، في مخيم عقبة جبر للاجئين القريب، تطل التلال الرملية الصلبة وفرشاة التنظيف على كتلة الرماد المنخفضة مترامية الأطراف والمساكن المبنية من الطوب اللبن.
وهنا، لا يزال الفلسطينيون يعيشون في ظروف قاسية، وفي الأشهر الأخيرة، كانت عقبة جبر هدفا دائما للغارات العسكرية الإسرائيلية الفتاكة، ما جلب الموت والدمار إلى أريحا.
ففي هذا العام وحده، عاش الفلسطينيون في الضفة الغربية 3 غارات إسرائيلية واسعة النطاق على الأقل، لم يكن العديد منهم قد ولدوا بعد عندما تم التوقيع على اتفاقات أوسلو، ومع ذلك فهم يشعرون الآن بغضب فشلها.